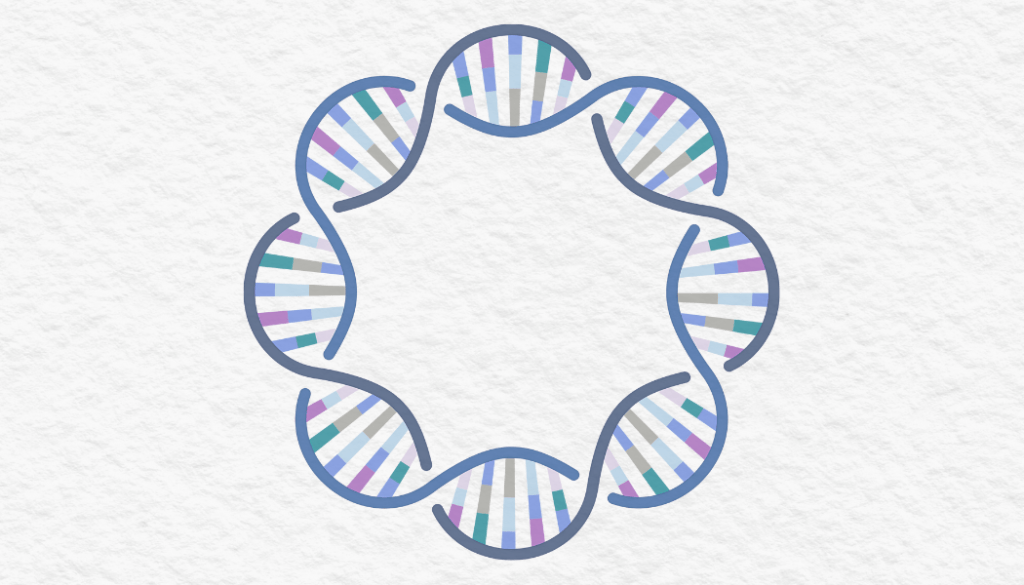
جميعنا يعرف أشخاصاً من هذا النوع، أشخاص عندما يسردون قصة نجد أنفسنا نستمع فعلاً. نتوقف عما نفعله، ننسى هواتفنا، ونصغي. وبعد أن نجد أنفسنا داخل القصة التي يحكونها، نبدأ نلاحظ كم هم ماهرون في سرد القصص. يعرفون كيف يشدّوننا، كيف يبنون التوتر، متى يجعلوننا .نضحك، متى نفكر، متى يكشفون المعلومة التي كنا ننتظرها. والغريب أن كل هذا يأتيهم بالفطرة
لو توقفنا قليلاً وأصغينا فعلاً لطريقة حديث الناس من حولنا وكيف يروون قصصهم، سنبدأ نلاحظ نمطاً في القصص التي تبقى معنا. هناك شكل معين تتخذه هذه القصص، شكل يحدث بشكل طبيعي
هذا الفن في رواية القصص قديم قدم الحكايات نفسها. الحكواتي الذي كان يروي قصص التاريخ والأساطير من مكان إلى مكان، استطاع أن يحفظ التراث ويحييه عبر الكلمة المنطوقة لأنه كان راوياً ماهراً أيضاً. كان يعرف، تماماً مثل ذلك الصديق الذي يشدّنا بقصصه، كيف يوقف الحكاية في اللحظة المناسبة، كيف يترك السامعين معلقين، كيف يبني طبقة فوق طبقة حتى تكتمل القصة. بسبب هذه المهارة استطاع الناس أن يتذكروا القصص ويحفظوها ويرووها لأجيال
عندما نستمع لهؤلاء الرواة الماهرين نلاحظ شيئاً آخر، هم لا يبدؤون من المنتصف أبداً ولا ينهون القصة قبل أن نعرف ما حدث فعلاً. يبدؤون بوضع المشهد “كنت في المطار…” ثم يحدث شيء يغيّر الوضع “وفجأة…” ثم نصل إلى ما تغيّر بسبب ذلك “وفي النهاية…”. هذا الشكل ليس صدفة. إنه الطريقة التي نفهم بها التجربة نفسها.
شيء يبدأ ويتطور ويتغير ثم ينتهي أو يستقر في شكل جديد. هذا الإيقاع موجود في كل شيء من يومنا العادي إلى اللحظات التي تغير حياتنا. ابن خلدون، في كتاباته التاريخية، رأى القصص كأنماط تكشف حقائق عن السلوك البشري والمجتمعات، كطريقة لفهم كيف تتكرر التجارب الإنسانية عبر الزمن. حتى القصص التي تُروى بشكل غير خطي أو تبدأ من النهاية ما زال هناك بنية تشكّلها من الداخل. البداية تضع السياق وتعرّفنا على العالم، الوسط يُدخل التعقيد والتغيير، والنهاية تمنحنا إحساساً بأن شيئاً ما اكتمل أو تحوّل.
عندما نسمع عن “البنية الثلاثية” أو “نقاط التحول” أو “الفصل الثاني”، قد نشعر أن شيئاً ما يحاول تقييد إبداعنا. نريد أن نبدأ بالكتابة مباشرة، أن نترك القصة تتدفق. وبعد كل شيء، ألم نكن نحكي ونستمع للقصص منذ الصغر؟ لماذا نحتاج أن نتوقف الآن ونفكر في شيء اسمه “البنية أو الهيكل”؟
لكن هذه الأدوات تخدم شيء بسيط: كيف تتحرك القصة عبر الأحداث وكيف نشعر بهذه الحركة. البداية تضعنا في العالم وتعرّفنا على من نتابع. الوسط يأخذ هذا العالم ويبدأ بتعقيده، يضع العقبات، يصعّد الصراع، ويدفع الشخصيات إلى اتخاذ قرارات أصعب. والنهاية تجيب على السؤال الذي طرحته البداية، ليس بالضرورة بإجابة واضحة، لكن بإحساس أن شيئاً ما اكتمل أو تغيّر بشكل لا رجعة عنه.
أحياناً القصة تجد شكلها بشكل طبيعي وكل شيء يسير بسلاسة، نجد أنفسنا نكتب مشهد تلو الآخر. لكن في أحيان كثيرة نصل إلى مرحلة في الكتابة نشعر فيها أن شيئاً ما لا يسير كما يجب. قد نكون في الصفحة الأربعين والقصة تبدو عالقة في مكانها. أو نصل إلى النهاية ونشعر أنها لا تحقق ما وعدت به البداية. أو المشاهد موجودة لكنها لا ترتبط ببعضها بطريقة تشعرنا أننا نتقدم إلى الأمام. البنية تساعدنا على تحديد هذه المشاكل. عندما نفهم ما يفترض أن يحدث في كل جزء من القصة، نستطيع أن نرى أين الضعف. هل البداية لم توضح ما يكفي؟ هل الوسط لا يزيد التوتر؟ هل النهاية جاءت من دون تحضير كافٍ؟ البنية خريطة تساعدنا على معرفة أين نحن وإلى أين نذهب.
منذ زمن أرسطو يحاول الناس فهم كيف تتكون القصص وما الذي يجعلها تشدنا. لاحظ أرسطو في كتابه «فن الشعر» أن القصص الدرامية تحتاج بداية ووسط ونهاية، وأن الأحداث يجب أن تتصل ببعضها بشكل منطقي. رأى أن القصص القوية تبني التوتر تدريجياً حتى تصل إلى لحظة حاسمة، ثم تأتي النهاية التي تحقق نوعاً من التطهير العاطفي للمشاهد. هذه الملاحظات عن التصعيد والسببية أصبحت أساساً لكثير من نظريات السرد التي جاءت بعده. ومع الوقت، طوّر الناس صيغاً مختلفة بناءً على هذه الملاحظات: البنية الثلاثية، رحلة البطل، الفصول الخمسة، البنية غير الخطية، وغيرها الكثير.
بعض القصص تحتاج بنية خطية واضحة، بداية ووسط ونهاية متتابعة. وبعض القصص تقفز في الزمن أو تبدأ من النهاية أو تروى من عدة وجهات نظر. في ألف ليلة وليلة، شهرزاد تستخدم التأخير والتشويق كأدوات للبقاء، تتوقف في اللحظة المناسبة وتترك السامعين معلقين، مما يجعل فعل السرد نفسه أهم من الوصول إلى نهاية. البنية غير الخطية خيار يتخذه الكاتب لسرد نوع معين من القصص، وبنية مختلفة ومصممة بعناية لتحقق تأثيراً معيناً. حتى عندما نكسر التسلسل الزمني، نحن نختار بوعي متى نكشف المعلومات وكيف ننتقل بين الأزمنة لبناء المعنى.
الفكرة أن نفهم لماذا هذه الصيغ موجودة أصلاً. البنية الثلاثية مثلاً ليست قاعدة بل ملاحظة لكيف تصاغ معظم القصص التي تشدنا. البداية تمنحنا سبباً للاهتمام، الوسط يجعل الأمور أصعب تدريجياً، والنهاية تحقق (أو تحطم) التوقعات التي بنيناها. عندما نفهم هذا، نستطيع أن نستخدمه أو نتحدّاه أو نعدّله حسب احتياجات قصتنا.
أحد أكبر الأخطاء التي نقع فيها في البداية هو التعامل مع البنية كقائمة مهام أو كأن اتباع بنية معينة يضمن أن القصة ستنجح. ما تفعله البنية هو أنها تمنحنا نقطة انطلاق، إطار نعمل من خلاله بدلاً من البدء من فراغ. تعليمات مثل “يجب أن تحدث نقطة التحول الأولى في الصفحة ٢٥” أو “يجب أن يترك البطل عالمه العادي بحلول الصفحة ١٢” أو “يجب أن يكون الفصل الثاني ضعف طول الفصل الأول” هي إرشادات تقريبية وليست قوانين. اتبعها إن أردت، طالما أنها لا تقيّد إبداعك فالقصص ليست وصفات نتبعها خطوة بخطوة. البنية أقرب إلى هيكل بناء، شيء يدعم القصة من الداخل دون أن يكون مرئياً أو صارماً.
ما يهم فعلاً هو ما نشعر به أثناء القراءة أو المشاهدة. هل نشعر أن القصة تتحرك؟ هل التوتر يتصاعد أم يبقى ثابتاً؟ هل النهاية تشعرنا أننا وصلنا إلى مكان جديد، حتى لو لم تكن كل الأسئلة محسومة؟ فالبنية الجيدة تصنع إيقاعاً عاطفياً، تأخذنا في رحلة نشعر بها حتى لو لم نستطع وصفها تماماً.
وأحياناً، البنية تظهر أثناء الكتابة وليس قبلها. قد نبدأ بفكرة ونكتشف أثناء الكتابة أن القصة تحتاج شكلاً مختلفاً عما خططنا له. ربما ما ظننا أنه البداية هو في الواقع نقطة التحول. ربما الشخصية التي كانت ثانوية تصبح المحور. البنية تتطور مع القصة ومع خيالنا.
في النهاية، البنية موجودة لتخدمنا كأداة. تساعدنا على رؤية القصة ككل، على معرفة أين نحن وإلى أين نحتاج أن نذهب. تمنحنا لغة لفهم ما يعمل وما لا يعمل. وعندما نفهمها جيداً، نستطيع أن نلعب بها، أن نكسرها، أن نعيد تشكيلها.
القصص تأخذ شكلاً لأننا نحتاج أن نشعر أننا نتقدم، أن شيئاً يتغير، أن هناك رحلة لها بداية ونهاية حتى لو كانت النهاية مفتوحة. البنية هي كيف نصمم هذا الإحساس بالحركة والتغيير. وعندما نفهمها، لا كقواعد لكن كخريطة، تصبح أداة نستخدمها لصناعة قصص أقوى وأكثر تماسكاً.